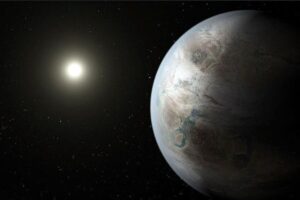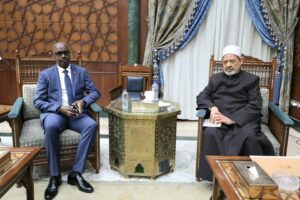أنقذت عملية حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، نتانياهو وحكومته اليمينية ، ولو وقتياً، من مُظاهرات شعبية غير مسبوقة، إستمرت نحو 9 شهور، ضد “الإصلاح القضائي” المزعوم، والذي كان النظام الصهيوني ينوي تمريره في إسرائيل.
ويعني الإصلاح القضائي الإسرائيلي، بإلغاء ما يُعرف بـ “معيار المعقولية” في القانون. وهو المعيار الذي يعمل على قيام القُضاة في المحكمة العُليا في إسرائيل، بمنع وإحباط أي قرار صادر عن الحكومة، يتنافى مع “المعقولية القانونية”، مثل تعيين شخص ما وزيراً، بينما هو متورط في قضايا فساد. ويقف شعب الكيان ضد تلك الإصلاحات القضائية المُفترضة، كونها تتناقض مع قواعد “الديمقراطية”، وفقاً لرؤيتهم.
وبدأ نتانياهو وحكومته المتطرفة في أعقاب عملية 7 أكتوبر بـ “إبادة” الشعب الفلسطيني في غزة، بهدف مُعلن يتمثل في القضاء على حماس، بينما هو بتلك العملية، وحال نجاحه في القضاء على حماس – رغم إستحالة ذلك حتى على المستوى النظري: قد خلق الملايين من المعتنقين عقيدتها، وحولها إلى رمز بطولة، رغم أنها – في حقيقة الأمر، ليست كذلك.
ويرى المُتابعون، أن هدف نتانياهو الحقيقي من وراء عملية إبادة أطفال غزة، هي تحويل القطاع إلى “أرض محروقة”، ومن ثم ضرب مُخيمات النازحين في الجنوب بجانب معبر رفح المصري، لإجبارهم على الهجرة إلى سيناء بشكل قسري.
وفي ذلك تصفية واضحة، للقضية الفلسطينية على مستوى قطاع غزة. ولذا يهتم القائمين على الأمور من الفُرقاء في الكيان وخارجه، بالحديث عمن سيُدير القطاع بعد عملية الإبادة تلك، حيث أن ذاك الأمر، هو محل خلاف كبير، لما يُمثله من نقطة فارقة في إستمرار أو زوال القضية الفلسطينية.
ومن المعروف أن النصر أو الهزيمة لأي جيش في أي حرب، يُحددا وفقا لـ “التوجيه الإستراتيجي” الموجه لقيادة الجيش قبل بدء المعركة. وبناءً عليه، فإن إسرائيل حتى الآن ووفقاً للتوجيه الإستراتيجي الخاص بتسوية غزة بالأرض، كمرحلة أولى، قد حققت هدف من أهداف حربها الجارية. فما أعلنته إسرائيل ذاتها من أنها تحارب لتقضي على حماس كهدف أساسي للحرب، يبدو خادعاً، لأنه أمر غير قابل للتطبيق وفقاً لأي عاقل، لأن الفصائل تزداد شعبية، بمُقاتلتها لجيش دولة إشتهر بالقوة والإنضباط والنظام، ومع ذلك تنتصر الفصائل في معارك كثيرة ضد أهم ألويته وتكبدها خسائر فادحة من المقاتلين والسُمعة الأمنية الذائعة السيط.
إلا أن تدمير غزة وإبادة الفلسطينيين فيها، لا يكفي كي تُعلن إسرائيل أي نصر حقيقي، يُرضي مواطنيها المتطرفين. فهذا الهدف، قلب الرأي العام العالمي عليها بشكل جارف، بحيث أصبحت شتى الشعوب في حالة كراهية مقيتة لإسرائيل، مهما بررت أفعالها، وبالذات مع صور جثث الأطفال الفلسطينيين الرُضع.
وإن كان هدف إسرائيل هو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مصر والأردن، فإن بداية مثل هذا الفعل، سيجر عليها وبال، لم تشهده طيلة تاريخها الممتد على مدار 75 سنة. فمستوى الكتائب الإسرائيلية المواجهة لمليشيات “مُقاتلي غزة”، إن كان تعبيراً عن الواقع، يُظهر أن مصر، ستشهد نُزهة في مواجهة جيش العدو الصهيوني. أما إن كان هذا الشكل، هو مجرد شكل للخداع، فهو أيضاً سيواجه هزيمة ساحقة، لأن الفرق شديد بين المُقاتل الذي يؤمن بالدفاع عن حدوده التاريخية وترابه الوطني الذي إستمر كذلك، لنحو 7000 سنة، وبين جنود العبرانيون الذين يهابون الموت في سبيل قضيتهم الواهية.
فالمسألة، ليست مُجرد سلاح يواجه سلاح، ولكنه يكمن في المقاتل وشخصيته وعقيدته أيضاً. وبتلك المناسبة، فإن هذا كلام الصهاينة أنفسهم في أعقاب حرب يونيو 67. ففي كتاب “تحطمت الطائرات عند الفجر”، للكاتب باروخ نادل، الصادر بالعربية في 1970، وفي الصفحة 258، قال جاسوس إسرائيلي في مصر، لقائد سلاح الجو الإسرائيلي في 30 مايو 1967، بأن عدد طائرات مصر الحربية أصبح يفوق عدد طائرات إسرائيل الحربية، ليرد قائد سلاح الجو الصهيوني قائلاً:”ولكن ذلك يتوقف على نوعية الطيار الموجود في الطائرة”!!
لقد عملت إسرائيل بكل ما أوتيت، ووفقا لمراحل مختلفة، على تنفيذ خطتها بتهويد نفسها والعمل حتى على طرد سُكانها العرب (أي الفلسطينيين، الذين لم يهجروا منازلهم في حرب النكبة سنة 1948). وجاء الوقت مع نجاح “المتطرفين” أثناء آخر إنتخابات لديها، كي تنفذ تلك الخطة إلى آخرها. وكما نعلم من التاريخ، ومن خلال القادة الحنجوريين؛ فإن هذا الأسلوب المتغطرس، يؤدي إلى الهزيمة النكراء.
ولذا، فإن القول بأن إسرائيل “أوحلت نفسها”، بمعنى أنها: “لا تستطيع أن ترجع إلى الوراء أو أن تتتقدم إلى الأمام”، هو قول دقيق. وما ينتظرها، سواءً حاربت مصر أو لم تُحارب، هو سقوط النظام السياسي فيها بأكمله، لتُجري إنتخابات متعددة ويدخل نتانياهو السجن لفساده على شتى المستويات الشخصية والوطنية، ولتعود الدولة المُحتلة إلى أزمة نظامها الداخلي من جديد، سواء كان الحديث عن الإصلاح القضائي أو عن “أزمة القيادة” التي تعانيها منذ تولي نتانياهو الحكم، والتي على ما يبدو ستستمر لفترةٍ ما.
فإسرائيل أجرت خمس إنتخابات تشريعية في أقل من 4 سنوات، وكان آخرها تلك التي جاءت بالمُتطرفين إلى السلطة في 1 نوفمبر 2022. وتعود الأزمة السياسية في إسرائيل، إلى كثرة الأحزاب منذ بداية الألفية نظراً لتغير فكر الأجيال الجديدة، وبالتالي المُجتمع الإسرائيلي برُمته، وهو الذي أخفق في تغيير نفسه مع الزمن.
ولقد جاء ذلك، بعد أن كانت الأحزاب في إسرائيل تتجسد بالأساس في كتلة الليكود وحزب العمل، مما جعل المنظومة السياسية في دولة الكيان المُحتل، تُجسد خلافات حادة حول تفاصيل عدة، حتى رأينا مُظاهرات ضد النظام مؤخراً وقبل إندلاع تلك الإبادة ضد الفلسطينيين، والتي يُراد بها ضمن أمور أُخرى، الإلهاء بعيداً عن الوضع الداخلي، والذي سيعود إليه مجمل المجتمع الإسرائيلي، وبصورة أكبر تراجيدية وبؤساً، بعد الإنتهاء من حملة غزة.
فإسرائيل بحاجة إلى إعادة النظر بشكلٍ كامل في نظامها السياسي وإستراتيجيتها العسكرية، والتراجع عن أحلامها الوهمية في إحتلال الأرض ما بين النيل والفرات، واللجوء إلى السلام الشامل العادل في المنطقة ككل والتصالح مع الشعب الفلسطيني، بقيادة إسرائيلية جديدة.
إن إسرائيل، تقترب من كارثة عسكرية حقيقية بسبب جمود فكر من يديرونها، وهو ما سيُثبت لأصحاب الفكر القديم والمُتطرف فيها، أن قطار التحديث الفكري، هو ما يجب أن يُدير الدولة، وإلا كانت الهزيمة التالية أكثر فداحة من الهزيمة الحالية.
فكما هو واضح، راهنت إسرائيل على الحُصان الخاسر، ولم تقرأ المشهد الإقليمي والدولي جيداً قبل حملة إبادتها لغزة. وعليه، فإنها خسرت المعركة الإعلامية بالفعل، وتتعمد خسارة المعركة الإنسانية يومياً، ظناً منها أن التقدم بآلة القتل، بإمكانه أن يأتي عليها بنصر ما، مثلما كان فيما سبق، ولكن من الواضح أن “قواعد اللعبة” قد تغيرت وتبدلت كثيراً، وإسرائيل لا تريد الإعتراف بذلك، لأن المُتطرفين في أي مكان، لا يعترفون بالحقائق، إلا بعد وقوع الكوارث الدالة عليها.
إننا على مقربة من لحظات الحقيقة، حيث بالإمكان الإنتصار بلا حرب، أو الإنتصار بحرب ضد عدو متطرف ومتغطرس، يظن أن السلاح فقط، هو ما سيحسم المعركة.
وإننا لمنتظرون لتلك اللحظة، على أحر من الجمر،
اللهم أنصر الشعب الفلسطيني،
والله أكبر والعزة لمصر.