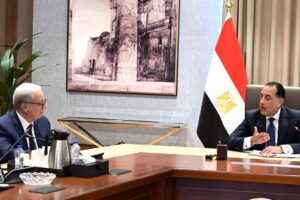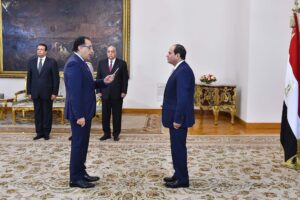حجم الأخبار والثرثرات والفيديوهات، المتداولة منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام العربي، عن الفنّان عمرو دياب وصفعته لأحد معجبيه ونكش ما قبلها من “سقطات” لألفاظ وتصرّفات عنيفة أو غير لائقة، يُعادل اليوم حجم شهرته ونجوميّته التي تعدّت منطقة الشرق الأوسط لتصبح عالمية.
هذا الحجم الهائل من النجاح المتراكم والمستمرّ منذ ثمانينيات القرن العشرين وحده كفيل بشنّ حملات وحملات مضادّة على “الهضبة”، سواء كانت تحريضية أو مدحاً أو ذمّاً.
لا يزال وسم #عمرو_دياب يحتلّ الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصفعة الشهيرة في أحد الأعراس في مصر. ولا يزال اللاهثون وراء الترند والترافيك والمزيد من اللايكات والقلوب الافتراضية الواهية، يبحثون عن أيّ خبر يتعلّق بهذا النجم الظاهرة علّهم يلحسون طيفاً من نجوميّته!
فأصبح “اللي يسوا واللي ما يسواش” يُنظّر بالعفّة وحقوق الإنسان وقيم اللاعنف، أو ينصّب نفسه محامياً عن المعجب الضحيّة أو عن عمرو صاحب القضيّة.
بعد الردّ القانوني من الطرفين على الواقعة، تصرّف “الهضبة” الذي يعرف جيّداً كمنتج لأعماله كيف يحرّك أصابع النجومية وصناعتها عبر سنين طوال.
ويستفيد من كلّ هذه “البهورة” أو “الهولّيلة” ليعلن بدء الاستعدادات لحفلته في بيروت الأحد 16 حزيران المقبل. وهي فرصة لينتقل الحديث عن ابن بور سعيد الذي ترجمت أغانيه إلى لغات عدّة ونال جوائز لا تحصى في تصدّره أكثر مبيعات الألبومات، من القاهرة إلى بيروت التي غاب عنها 23 سنة ليعود العام الماضي بحفلة استثنائية حضرها آلاف. ويعيد الكرّة هذا الأسبوع مع بطاقات بأسعار أغلى وجمهور ربّما أكثر.
“شوّقنا” في عزّ الحرب
لكنّ جمهوره البيروتيّ يُعيد اليوم حساباته بنجمه المفضّل، وأنا واحدة منه. لقد رقصت معه على المسرح في الجونة ولحقت بحفلاته في أكثر من بلد، وكنت أحلم منذ كنت صغيرة في التاسعة من عمري، حيث اشترى لي أبي أوّل شريط كاسيت كان “شوّقنا” (1989) ونحن في مشوار إلى البقاع عن طريق الجبل حيث تنتشر الحواجز الأمنيّة الميليشياوية، قبل انتهاء الحرب الأهلية.
ذكريات الطفولة والعائلة
صارت موسيقى دياب هي التي تجمع العائلة بعدما كانت فيروز وعبدالحليم (لم أكن بعد اكتشفت أمّ كلثوم)، مع أنّ ذوق أبي الموسيقي كلاسيكي جداً ولا يضع أحداً بمرتبة كارم محمود والرحابنة وعبدالوهاب وعبدالمطلب. فصرنا كلّما أصدر دياب كاسيت نشتريه ونستمع إليه في مشاويرنا الطويلة العائلية.
أنا الزعيم
تلك الواقعة جعلتني أتوقّف عن البكاء كلّما سمعت هذه الأغاني وأستمتع بالرقص والميلودي. واليوم انتبهت بعد كلّ هذا الشتم والذمّ والاعتراض إلى تصرّفات صاحب “علّم قلبي الغرام”، التي أدينها طبعاً، إلا أنّه لم يكن عنيفاً معي كمعجبة اخترقت المسرح من شدّة حماستها. ترك لي فرصة لأعبّر ربّما عن كلّ هذا الحبّ الذي يمثّله جيلي من اللبنانيين شباباً وبنات.
وشكرني باحترام وانسحبت باحترام. مع أنّني أقرّ اليوم أنّ الفكرة قد لا تروق لفنّان مثله ويحقّ لحرّاسه منعي من اقتحام المسرح. وقد حضرته مرّات عدّة بعدها والتقيت به من بعيد في “أماكن السهر” في مصر، لكنّني لم ألحظ هذا التعجرف وهذه الفوقيّة اللذين تصوّرهما لنا فيديوهات السوشيل ميديا!
فكّرت كثيراً لماذا يُقدم فنّان بهذا الحجم، وهو الموصوف بالفنان الذكيّ الذي يعرف كيف يُحرّك مفاتيح ظهوره الإعلامي ويدرس خطواته وتصريحاته وانحيازاته السياسية أو حياديّته حيال أيّ قضية كانت حتى الثورة المصرية أو الحرب على غزة، على هذه السلوكيّات العنيفة؟ فالفيديو الذي “يلتقط سقطته” بالجرم المشهود، بدا فيه سريع الانفعال ومزاجه متعكّراً.
هل وصل عمرو دياب إلى مرحلة القدسيّة معتبراً نفسه “أنا الزعيم” القابض على هضبات الفنّ العربي بيد من حديد؟ هل هو يعاني من النرجسية التي تُصاب بها غالبية المبدعين ولاحقت مادونا وتشارلي تشابلن وبيكاسو وسالفادور دالي وكانييه ويست؟ وكلّهم مارسوا أنواعاً مختلفة من أذيّة الآخر وحتى أقرب الناس إليهم.
رُهاب التّلامس الجسديّ
قبل الصفعة كان سميث يقع على رأس قائمة أكثر 10 نجوم يُنظر إليهم بإيجابية، بـ39 نقطة تحديداً، لكنّ ذلك تغيّر بعد الواقعة ليبلغ تصنيفه 24، وذكر البعض أنّه وصل إلى 19. لكنّ سميث استطاع بفضل شركات الإنتاج التي تحمي ظهره العودة إلى هوليوود والاستثمار في الصفعة نفسها في فيلمه الجديد “تحرير” الذي يحقّق نجاحاً كبيراً على شبّاك التذاكر في الولايات المتحدة. فسميث ممثّل جدير وحائز أوسكار.
أخطأ طبعاً واعتذر وغاب عن النجومية سنتين، لكنّه عاد بقوّة. فهل يعتذر عمرو دياب عمّا فعل؟ وهل تؤثّر هذه السلوكيات على جمهوره أو حفلاته وخصوصاً حفلة بيروت؟ إنّ الأحد لناظره قريب.
خطّة ثوريّة بنَت قاعدة جماهيريّة
الناس والفسابكة، كما يصفهم عالم الاجتماع أحمد بيضون، سينسون هذه الواقعة. وعمرو دياب سيبقى ظاهرة لها رمزية خاصة في عالم الغناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما كان مايكل جاكسون ظاهرة لم تتكرّر، على الرغم من كلّ أفعاله وسلوكياته السيّئة السمعة.
ما بناه عمرو دياب خلال 40 سنة من عمره الفنّي تقريباً، ومنذ ألبومه الأوّل “غنّي من قلبك” في عام 1984، ثبّته على عرش موسيقى البوب. فهو يجمع كلّ مكوّنات الظاهرة الفنّية (موهبة، نجاح مستمرّ، هويّة فنّية، جماهيرية تتعدّى حدود البلاد العربية) التي تدخل ضمن الذاكرة الجماعية ووجدان الأجيال. وذلك بغضّ النظر عن القيمة الفنّية الخالصة لما يقدّمه. فكثيرون لديهم نظرة نقدية حادّة لموسيقى عمرو دياب، لكنّهم لا يستطيعون نكران كونه ظاهرة.
أوّلاً لأنّه اختار منذ كان شابّاً صاعداً طريقاً مختلفاً لصناعة نجوميّته، وأدرك باكراً أنّ النجومية ليست موهبة وألحاناً فحسب، بل صناعة إبداعية وإنتاج وإدارة وتحتاج إلى رؤية وهويّة واستراتيجية وكثير من الفلوس، وذلك بموازاة صناعة الصورة والمظهر الخارجي وتصريحاته وطلّاته الإعلامية وسلوكيّاته وصولاً إلى مواقفه السياسية.
التّحرّر من الماضي وصناعة النجوميّة
تحرّر دياب من عبء الماضي ولم يقارن نفسه بالعمالقة ولم يقلّدهم، بل رسم خطّة التميّز عن مطربي الجيل الأقدم منه والمعاصر له. خطة تغييرية ثورية في عالم البوب العربي بدءاً من ابتعاده عن نجوم الشعر الغنائي (الأبنودي وعبد الرحيم منصور ومجدي نجيب وغيرهم) واختياره كتّاباً شباباً جدداً ومنهم مراهقون، وصولاً إلى انتقاء فريق عمل متجدّد من ملحّنين وشعراء وموزّعين موهوبين من أجيال مختلفة وخلفيّات وخبرات مختلفة. استطاع مخاطبة الموسيقى العالمية بكلّ أطيافها وتنويعاتها و”هيتاتها”، من الغجرية إلى اللاتينية وموسيقى جنوب أوروبا وحوض المتوسّط من دون طلاق الموسيقى الشرقية وقوالبها ومقاماتها.
ولكنّ إيقاع المقسوم كان الخطّ الجامع لأغانيه التي تعتمد على الصوت الموسيقي وجمله القصيرة. فهو يفهم الذوق العامّ وما يحتاج إليه السوق، وصوته عذب مرِن، ويمكنه أداء ألوان مختلفة من الموسيقى. هذه جرأة مبكّرة تُحسب للهضبة وبنَت له قاعدة جماهيرية من الصعب خلخلتها.
هذه الظاهرة الموسيقية الثابتة والمصنوعة بحِرفية جعلت مجلّة “رولنغ ستون” الأميركية المتخصّصة في الموسيقى تصنّف أغنية “تملّي معاك” التي تُرجمت إلى 15 لغة، وبعد 24 سنة من إصدارها، في المركز الأوّل كأفضل أغنية في القرن الـ21 في منطقة شمال إفريقيا والوطن العربي.