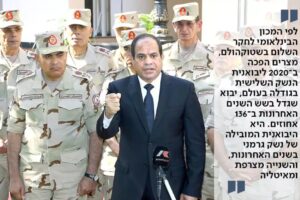مقدمة:
مثل الهجوم المباغت وغير المسبوق لفصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات جنوب إسرائيل المعروفة بـ”غلاف غزة” صباح يوم السابع من أكتوبر 2023م، صدمة جماعية داخل إسرائيل على جميع المستويات الرسمية والشعبية؛ إذ عُد هذا الهجوم بمثابة تهديد جماعي وجودي، على نحو ما عبرت عن ذلك مفردات ومضامين الخطاب الرسمي للقادة الاسرائيليين على المستويين السياسيين والعسكريين، وكذلك الخطاب غير الرسمي للمراقبين الأمنيين والخبراء الاستراتيجيين في تعقيباتهم المتوالية على الهجوم.
وبدا أن هناك إجماع في إسرائيل على أن عملية “طوفان الأقصى” باتت حدثاً قياسياً يؤرخ بها ولها، حيث غدت أوضاع ما بعد 7 أكتوبر 2023م مغايرة تماماً لتلك التي كانت سائدة قبل هذا التاريخ؛ وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا الحدث المزلزل على الصُعد كافة لاسيما الأمنية والعسكرية.
فقد شكل فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية معلماً رئيسياً في المشهد الاستراتيجي العام الذي صاحب الهجوم الفلسطيني المباغت والمزدوج على مستوطنات غلاف غزة، حيث وصفت وسائل الإعلام في إسرائيل الإخفاق في توقع هذا الهجوم – فضلاً عن عدم إحباطه وانهائه في أسرع وقت- بـ “القصور المُجلجل والمُهين” لاستخبارات تل أبيب الداخلية (أمان والشاباك)، والخارجية (الموساد).
وإذا كانت هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الإخفاق، فإنها بلاشك أول سابقة على صعيد عدم القدرة على التنبؤ الاستخباراتي فيما يخص التحركات في الأراضي المحتلة وخصوصاً قطاع غزة، المفترض أنه يحظى بتركير فائق من هذه الوجهة، لاعتبارات أمنية وعسكرية عدة.

فقد تجلى الفشل الاستخباراتي الأكبر في تاريخ إسرائيل في مفاجأة حرب أكتوبر عام 1973م، وهو الفشل الذي كان محور التحقيقات التي أجرتها “لجنة أجرانات” بعد الحرب. كما أخفقت الاستخبارات الإسرائيلية في توقع اندلاع الموجة الأولى من الانتفاضات العربية عامي 2010-2011م، ولم يكن أخر مظاهر الرسوب الاستخباراتي لاسرائيل هو تفاجئها بنشوب الاقتتال الداخلي بين جناحي المكون العسكري بالسودان في منتصف إبريل 2023م.
في ضوء ذلك، يجتهد هذا التحليل الموجز في تقديم إجابات معقولة عن عدد من التساؤلات المهمة، في مقدمتها مايلي:
– كيف كشف “هجوم 7 أكتوبر” عن الاخفاق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي؟ ولماذا حدث على هذا النحو الدراماتيكي غير المتوقع؟
– ماهية التغييرات التي سوف يُحدثها هذا الهجوم الصاعق في التفكير العسكري والاستخباراتي داخل داخل إسرائيل؟
بعبارة أخرى، كيف مثل الهجوم صدمة للأوساط العسكرية والأمنية عموماً والأجهزة الاستخباراتية على وجه الخصوص؟، وما هي تداعيات هذه الصدمة في المستقبل المنظور على أقل تقدير؟
تأسيساُ على ما تقدم، يسلط هذا التحليل الضوء على معالم وملامح “صدمة 7 أكتوبر” من المنظور الأمني-الاستخباراتي، ويناقش العوامل المفسرة لحدوث الهجوم على النحو الذي وقع به، ثم يُعرج على بيان تداعياته وفق المعطيات الأمنية والعسكرية، ويختتم باستشراف مستقبل النموذج الأمني والاستخباراي في مرحلة مابعد “11 سبتمبر الإسرائيلي”.
أولاً- معالم صدمة 7 أكتوبر:
مثلت عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في فجر 7 أكتوبر 2023م صدمة مصحوبة باندهاش وذهول وهول رسمي وشعبي لم تعهدهما إسرائيل منذ نصف قرن خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973م.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن يكون هذا الحدث موضوعاً لتساؤلات شائكة ونقاشات حادة وتقييمات مُعمقة من جانب النخبة الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية بمختلف تصنيفاتها السياسية وانتمائتها الحزبية وتوجهات الايديولوجية، وإن كانت دوائر صنع القرار الأمني والعسكري والاستخباراتي، ومراكز الفكر الاستراتيجي المُعتبرة قد كان لها النصيب الأوفر والأكثر عمقاً من حيث الاهتمام بتوصيف هذا الحدث المركزي، وتحليله، واستنتاج دلالاته؛ بغرض استلهام الدروس والعبر، وصياغة رؤى واستراتيجيات تجاه مستقبل إسرائيل ما بعد حرب غزة، التي برز إجماع على أنها في كل الأحوال ستكون مختلفة تمام الاختلاف عن “إسرائيل 6 أكتوير 2023م”.

واعتبر قطاع عريض من المحللين والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين أن ما حدث في 7 أكتوبر، لم يكن مفاجأة باهظة الثمن ناجمة عن الفشل العملياتي والاستخبارتي فحسب، لكنه أيضاً صدمة للوعي القومي الإسرائيلي سوف تمتد آثارها العميقة في المجتمع بجميع مكوناته على مدى سنوات قادمة.
وتبدى حجم صدمة الأوساط الأمنية والاستخباراتية خصوصاً من هذا الهجوم، في نوعية ودلالات المفردات التي استخدمت في توصيفه.
فقد وصفه استراتيجيون إسرائيليون ذائعو الصيت بأنه “كان يوم عاصف لم يشهد مثله اليهود منذ “الهولوكوست”( )، فيما اعتبره آخرون بمثابة “11 سبتمبر الإسرائيلي”( )، على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي ضربت الولايات المتحدة الأميريكية عام 2001م.
ووصل الهلع والارتباك الامني حده لدرجة حديث بعض الوزراء ونواب “الكنيست” عن إمكانية استخدام “الخيار النووي” في غزة كرد انتقامي مما حدث في 7 أكتوبر.
وثمة مؤشرات عديدة ومتنوعة أمكننا رصدها تبين ماهية صدمة إسرائيل، الدولة والمجتمع، من “واقعة 7 أكتوبر”، وأهمها مايلي:
1- للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر عام 1973م، أي منذ خمسة عقود كاملة، تفشل أجهزة الأمن والاستخبارات الاسرائيلية في توقع هجوم بهذا الحجم والكيفية، ومن ثم تخفق في توجيه إنذار مبكر إلى القيادة السياسية.
ولذلك؛ اعتبر استراتيجيون إسرائيليون أن يوم 7 أكتوبر 2023م،كما كان “يوماً قاتلاً” للأجهزة والمؤسسات الأمنية التي وقعت في أخطاء استراتيجية، حيث عجز “جيش الدفاع” عن توفير الأمن للإسرائيليين الذين قتل أكثر من 1200 منهم في ذلك اليوم، ووقع العشرات في الأسر بيد حركة “حماس”( )، وذلك في بلد يفترض أن الأمن هو الأولوية المطلقة للدولة والشعب.
2- لأول مرة في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تواجه تل أبيب “معضلة ثلاثية الأبعاد”غير مسبوقة، تمثلت في أخذ المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة “حماس” لرهائن، ليس هذا فحسب، بل وأخذ أعداد كبيرة منهم (أكثر من 240 رهينة)، وزد على ذلك تنوع هويات هؤلاء الرهائن ما بين مدنيين وعسكريين برتب مختلفة ومزدوجي الجنسية وأجانب.

3- للمرة الأولى منذ 50 عاماً أيضاً، تًعلن إسرائيل “حالة الحرب” رسمياً؛ وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتل أبيب، على المستوى القانوني والعلملياتي فضلاً عن مستوى الوعي الجمعي العام.
وقد كان لهذا الأمر تأثيره الحاسم في تحديد الأهداف الاستراتيجية العملية العسكرية التي حملت اسم “السيوف الحديدية” التي أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة رداً على عملية “طوفان الأقصى”، حيث تمثلت تلك الأهداف في: استعادة جميع الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر في غزة، والقضاء نهائياً على حركة حماس وقادتها واقتلاع جذورها من القطاع، ومحو نفوذها وتأثيرته على الساحة الفلسطينية.
ثانياً- الفشل الاستخباراتي و”قدسية” الأمن الإسرائيلي
يتصدر الأمن سلم الأولويات الإستراتيجية في العقل والوجدان الجمعي الإسرائيلي على نحو ليس له مثيل في دول العالم قاطبة، حيث يشكل مسألة وجود وبقاء للدولة والمجتمع، وذلك إلى حد ذهب معه الرئيس الأسبق شمعون بيريز للقول أن الأمن يجب أن يتقدم اهتمامات الإسرائيليين جميعاً حتى قبل تنفس الهواء.
وذهب البعض للقول بأن “الدستور الوحيد الموجود في إسرائيل منذ ديفيد بن جوريون حتى بنيامين نتنياهو هو دستور الأمن”، وبالتالي أصبح الحفاظ على أمن الدولة وسلامتها الوجودية أبرز ثوابت الإجماع القومي في إسرائيل منذ تأسيسها وحتى الآن. كما بات الأمن الموجه الرئيس لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سلماً وحرباً، والمرتكز الحاكم لإدراك نخبتها بغض النظر عن انتماءاتها الأيديولوجية ومواقفها السياسية، ومن المرجح أنه سيظل كذلك أيضاَ خلال المستقبل المنظور والبعيد.
ونتيجة لهذا الهاجس الأمني، وطغيان الطابع العسكري على كافة مناحي الحياة العامة، تحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع الثكنة العسكرية.
واستناداً لهذا الإدراك، صاغت القيادات المؤسسة لاسرائيل فرضيات أساسية شكلت في مجملها ما اصطلح على تسميتها بـ”ثقافة الأمن الإسرائيلية”، والتي أصبحت بمثابة المبادئ الحاكمة لإدراك وسلوك القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، والتي تربط بقاء الدولة باستمرار دعم المؤسسة العسكرية.
في ضوء ما تقدم، يبدو من الوهلة الأولى أن الفشل الاستخباراتي في توقع هجوم بحجم ونوع “طوفان الأقصى”، يعتبر أمراً مثيراً للدهشة والحيرة والاستغراب؛ وذلك بالنظر إلى الطبيعة العسكرية لهذا الهجوم وضخامته وتعدد المحاور التي شملها براً وبحرأً وجواً، ما يعني أن هناك جزء مهما من ذلك الهجوم تم التدريب عليه سابقاً ولعدة مرات، في ساحات مفتوحة لا يمكن التكتم عليها مطلقاً بعيدأً عن أعين ومراقبة الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديداً ما يخص التدريب على “الإسقاط بالمظلات”، والذي تم بسرعة واحترافية كبيرة خلف خط الدفاع العملياتي في مستوطنات غلاف غزة.

ولذلك، يثور “التساؤل اللغز” بشأن تفسير هذا الإخفاق في ضوء أن الأمن محدد حاكم لإدراك النخبة لقضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما ينسجم مع تصدر الهاجس الأمني سلم أولويات الإجماع القومي داخل إسرائيل.
حيث من المفترض- نظرياً- أن النخبة العسكرية والسياسية الإسرائيلية تميل إلى التعامل مع التهديدات الماثلة أوالمحتملة والتخطيط لمواجهتها وفقاً لتوقع “السيناريو الاسوأ”، وذلك كانعكاس للتشاؤم والحذر المبالغ فيه باعتبارهما من أبرز السمات النفسية للشخصية الإسرائيلية.
ثالثاً- العوامل المفسرة لمفاجأة “طوفان الأقصى”.. لماذا حدث ما حدث؟
تعددت التفسيرات وتباينت التقديرات والتأويلات التي طرحها الخبراء والمراقبون الإسرائيليون وغيرهم بشأن العوامل المسئولة عن توفير الظروف المواتية لتنفيذ عملية “طوفان الأقصى” ونجاحها على الوجه الذي تمت عليه.
لكن إجمالاً، برز إجماع بين المراقبين والمحللين على أن هجوم 7 أكتوبر هو في المحصلة النهائية نتيجة فشل أمني واستخباراتي مركب متتابع؛ فلم يتوقف الأمر عند حد الإخفاق الكارثي بتوقع الهجوم، لكن الفشل الاستخباراتي امتد تالياً مع دحض التجربة الميدانية عقب اقتحام مستشفى الشفاء في غزة خلال العملية البرية، لزيف إدعاءات الجيش الاسرائيلي بوجود “معلومات استخباراتية موثوقة” تفيد بأن حركة “حماس” تستخدم هذا المجمع الطبي مركزاً للقيادة والتحكم وتخزين السلاح والذخيرة في أنفاق موجودة أسفله( ).
ثم تكثل الفشل الاستخباراتي الثالث ذو الصلة بـ”طوفان الأقصى”، في الإخفاق الاسرائيليفي جمع معلومات معتبرة تفيد في تحديد أماكن احتجاز الرهائن في غزة من أجل استرجاعهم بالقوة باعتبار ذلك أحد أهم أهداف عملية “السيوف الحديدية” على القطاع.
وإزاء هذا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي المتكرر للمرة الثالثة، قامت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بتسيير طائرات مسيرة بدون طيار فوق غزة لمساعدة تل بيب في هذه المهمة. وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بعد استئناف الحرب عقب انتهاء هدنة السبعة ايام المؤقتة (24-30 نوفمبر 2023م)، عن تسير رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة .
وقد اعترف قادة ورؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بوجود فشل واضح لا يمكن إنكاره في توقع هجوم حماس.

فبعد ساعات من الهجوم، أقر كل من رئيس هيئة الأركان في الجيش هرتسي هاليفي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” أهارون هاليفا بهذا الفشل. وأعرب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار في رسالة بعث بها إلى عناصر الجهاز عن تحمله مسؤولية هذا الفشل.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي بعد أسبوع من الهجوم “إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات الاستخباراتية”، لافتاً إلى ملاحظة جوهرية بالقول “أعتقدنا حقا أن حماس تعلمت الدرس من آخر حرب مع إسرائيل عام2021م” .
بل إنه حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قال إنه يتحمل جزءا من المسؤولية، لكونه كان قاد إسرائيل لمدة 12 شهرا بين عامي 2021و 2021م، حين كانت كانت حماس تعد العدة لهجومها المباغت) (.
لكن على الرغم من هذا الاعتراف الصريح بالفشل، حاولت بعض دوائر الاستخبارات الإسرائيلية إيجاد تبريرات وذرائع تقلل من حدته، عبر إلقاء الجانب الأكبر من المسئولية عل عاتق القيادة السياسية وتحديداً شخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتجاهله تحذيرات الاستخبارات من التأثيرات السلبية المحتملة للتوترات الداخلية في إسرائيل بسبب مشروع “إصلاح القضاء” الرامي إلىالحد من صلاحيات المحكمة العليا خاصة في محاسبة رئيس الحكومة، وهو ما اثار انقساماً واستقطاباً سياسياً حاداً طال حتى المؤسسة العسكرية بأفرعها المختلفة وبما فيها جنود الاحتياط، وأطلق تظاهرات شعبي حاشدة بشكل أسبوعي اعتراضاً على هذا القانون منذ طرحه أواخر العام الماضي 2022م.
وفي هذا السياق التبريري، قال رئيس وحدة الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” الجنرال آميت ساعر أنه تم تحذير نتنياهو مرتين في 19 مارس و16 ويوليو الماضيين، من أن الانقسام السياسي المتزايد في إسرائيل يسيمح للمخاطر الأمنية الخارجية بالتنامي، وسيشجع خصومها المتربصين، مثل: إيران وحزب الله في لبنان و””حماس”، على شن هجمات عسكرية ضدها)

وعزز بعض المحللين الإسرائيليين، هذا الموقف التبريري من قبل أجهزة الاستخبارات، معتبربن أن الأزمة الداخلية التي استحكمت مع قانون الحد من صلاحيات المحكمة العليا، شجع “حماس” على تنفيذ هجومها، إذ رأت الحركة أن هذه الأزمة تؤثر سلبا على التماسك الداخلي وتثير الفوضى الأمنية والهشاشة المجتمعية، على نحو يصرف نظر إسرائيل ولو مؤقتاً عن غزة ومتابعة ما يجري فيها( ).
وبوجه عام، يمكننا القول بقدرٍ عالٍ من الاطمئنان أن الإخفاق الاستخباراتي والأمني من جانب إسرائيل في التنبؤ بعملية “طوفان الأقصى”، يُعزى إلى مجموعين رئيسيتين متكاملتين من الأسباب، بعضها يخص تل أبيب، والبعض الآخر يتصل بحركة حماس، وهو ما نوجزه على النحو التالي:
ا)- العوامل المرتبطة بإسرائيل، وتشمل:
أ- إشكاليات جمع المعلومات الاستخباراتية:
إذ يبدو على نحو جلي اعتماد تل أبيب بشكل مفرط أكثر من اللازم على المصادر الإلكترونية مقارنة بنظيرتها البشرية لرصد التحركات الميدانية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، التي بدورها اتقنت التمويه على المراقبة الاسرائيلية عن بُعد؛ مما أفقد إسرائيل القدرة على الوصول المبكر والموثوق للخطط العملياتية والاستراتيجية للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بالقطاع، لاسيما: كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
ب- الانشغال الاستخباراتي بتهديدات قريبة أقل خطورة:
فقد ركز جها الأمن العام الداخلي (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي جهودهما قبيل هجوم 7 أكتوبر، على رصد وتحليل التهديدات المحتملة من الضفة الغربية، ومنحها أولوية نسبية أكبر من نظيرتها المتوقعة من قطاع غزة.
ج- الفشل في تحليل التطور النوعي في قدرات حركة “حماس” وخططها العسكرية:
اذ ركزت دوائر الأمن وأجهزة الاستخبارات على تقليل مخاطر الصواريخ التي تنطلق من غزة، وتقليص خطر الأنفاق، لكنها أغفلت تتبع وتحليل القدرات والخطط العسكرية، ومن ثم أخفقت في توقع قيام الحركة بهجوم بري على نحو ما حدث.
د)- الاسترخاء العسكري المفرط الناجم عن غطرسة القوة:
فقد اهتمت إسرائيل بالابعاد التكنولوجية لحماية الحدود مع قطاع غزة، عبر بناء سياج حدودي ممتد، وتزويده بأجهزة المراقبة المتطورة عن بعد وبالونات التجسس المعروفة بـ”سكاي ستار” المجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار وتجسس بالغة الدقة، لكن في المقابل تم تقليص أعداد القوات العاملة في محيط القطاع( ).
وهذا يفسر، جزئياً، عدم القدرة على حتى توفير رد مباشر فوري على مثل هجوم 7 أكتوبر عند وقوعه.
إضافة إلى التقارير التي كشفت لاحقاً عن انه حتى بالونات التجسس هذه كانت معطلة أو لم يتم تحديثها أو صيانتها بشكل صحيح قبل الهجوم المذكور( )، مما ترك ثغرة خطيرة في الدفاعات الإسرائيلية.

هــ)- عدم القدرة على تصور حدوث سيناريوهات محددة:
يرى كاتب هذه السطور أن البيئة النفسية والسمات الشخصية لقادة صنع واتخاذ القرار الأمني في إسرائيل، لعبت الدور المركزي الأعظم في إدراك هذه القيادات للمعطيات المعلوماتية التي بين يديها بخصوص التحركات الميدانية والعملياتية في غزة عشية هجوم “طوفان الأقصى”؛ ومن ثم شكل هذا الإدراك الانتقائي المحدد الأكبر في توجيه تحرك أجهزة الاستخبارات فيما يخص رفع إنذار مبكر للقيادة السياسية ممثلة في رئيس الوزراء، بهجوم وشيك أو محتمل من غزة على إسرائيل.
إن إنعام النظر في الخبرة التاريخية والمعاصرة لتعامل أجهزة الاستخبارات في إسرائيل مع منظومة المعلومات الواردة إليها من مصادرها المختلفة، بشأن التهديدات المحتملة أو الوشيكة، تُظهر تغليب قيادات هذه الأجهزة (الشاباك، أمان، الموساد)- في أحيان كثيرة- لقناعاتها الذاتية المبنية على الخبرة والإدراك المسبق والصور الذهنية المستقرة، أكثر من تركيزها على ماهية هذه المعلومات وما تتضمنه من محتوى اقعي، لاسيما إذا كان هذا المحتوى يتعارض مع القناعات والمدركات الموجودة داخل هذه الأجهزة.
ومن ثم، يبدو يرى كاتب هذه السطور أن الإدراك السياسي والعسكري لقيادة الاستخبارات الإسرائيلية لعب دوراً رئيساً فيما يخص تقييم وفلترة المعلومات التي وردتها بشأن التجهيز لهجوم حركة “حماس” المزدوج “طوفان الأقصى” وتوقيته ونوعيته.
ولتوضيح هذا الأمر، ربما يكون مفيداً ان نعرج في عجالة على الدور الذي يلعبه الإدراك السياسي في صنع واتخاذ القرار.
فمن منظور علم السياسة، تتجلي أهمية الإدراك في أن السياسات عادة ما تُبنى انطلاقًا من إدراك صانع القرار لمواقف معينة، حيث تؤثر مدركاته النفسية وسمات شخصيته وتصوراته المسبقة في إضفاء تآويلات محتملة للواقع، ومن ثم تساهم في تشكيل استجابته وردود أفعاله إزاء المواقف والأحداث المختلفة.
ويرى أنصار المدرسة النفسية الإدراكية في العلوم السياسية، من أمثال: هولستي وروبرت نورث وريتشارد برودي وغيرهم، أن الإدراك السياسي للنخبة في دولة ما، إنما يعبر عن رؤيتها لموقف سياسي معين، داخلي أوخارجي، وطبيعة تأويلها لهذا الموقف، وتفسيرها له، وتصورها للكيفية المثلى للتعامل معه، من منظور المصلحة العليا للدولة.
كما أن للسمات الشخصية دوراً محورياً في تحديد الإختيار الإدراكي وخاصة ما يُعرف بـ”الإدراك الانتقائي” الذي يعد أداة رئيسة يلجا إليها الفردُ لتقليص التناقض بين المعلومات الجديدة وتصوراته السابقة، وهو ما يترتب عليه سوء في الإدراك، أو “خداع الإدراك”؛ الذي يعني إدراكات مضطربة أو قائمة على سوء تأويل الواقع وتشوه عملية قراءته، أوالمبالغة في تصور خطر معين أو ما تطلق عليه دراسات علم النفس التجريبي “الخطر المُدرك”.
يعني ذلك أن الإدراك يتحدد بالشخص المُدرك أكثر ما يتحدد بالموقف أوالظاهرة الموضوعية؛ ولذلك فإن العملية الإدراكية غالباً ما يشوبها التحيز. ويزداد التأثير النسبي للعوامل الذاتية في تأويل الموضوع المُدرك وتكيف إدراكه، كلما اتسم هذا الموضوع بالجدة أوالمفاجأة أو الغموض، أو إذا كانت البيئة أوالسياق العام لهذا الموضوع ذو طبيعة معقدة، أوحدث في ظروف غير مألوفة. وفي مثل هذه الحالات، يتم استدعاء الخبرة السابقة للإنسان عن الموضوع المُدرك، والاستناد إلى معتقداته وقيمه واتجاهاته إزاء هذا الموضوع؛ لفهمه وإدراكه.

وإذا ما حاولنا تطبيق ذلك على حالتنا الراهنة، المتمثلة في الكيفية المفترض أو المتصور أن تعاملت بها الاستخبارات الاسرائيلية مع توقع هجوم “طوفان الأقصى”، وبالتالي أفضت إلى هذا الفشل الاستخباراتي التاريخي، سنجد أننا إزاء ثلاثة سيناريوهات رئيسية، هي:
1)- سيناريو (عدم انعدام معلومات استباقية عن الهجوم):
يمكن القول بقدر كبير من الاطمئنان ان هذا الأمر مستبعد لاعتبارات عديدة، أهمها: أن هذا الهجوم يتعلق بالاختراق المباشر للعمق الإسرائيلي الضيق، وتوجد شبه استحالة في عدم وجوج حجم هائل من المعلومات حول كل “شاردة واردة” تتصل بهذا المحيط الوجودي وليس الحيوي فقط للأمن الإسرائيلي، ناهيك عن الامكانات التي تمتلكها استخبارات تل أبيب.
2)- سيناريو (تجاهل المعلومات الاستباقية عن الهجوم):
يقوم هذا التوقع على أن افتراض تلقي أجهزة الاستخبارات في تل أبيب لمعلومات مؤكدة من مصادر متنوعة ومتواترة عن الهجوم الفلسطيني، ولكن تم تجاهل هذه المعلومات؛ في ضوء قناعة مؤداها استحالة وقوع مثل هذا الأمر.
3)- سيناريو (التأويل المتحيز للمعلومات الاستباقية عن الهجوم):
يفترض هذا التوقع قبول الأذرع الاستخبارتية الإسرائيلية أو بعضها لجزء من المعلومات الاستباقية المؤكدة التي وردتها، واستبعاد أخرى، كأن تكون هذه قيادة الاستخبارات اقتنعت بأن هناك هجومأً وشيكاً من قطاع غزة، لكنها رفضت تصور أن يأتي هذا الهجوم المتوقع بالكيفية التي تم عليها.
وفي كلا السيناريوهين الثاني والثالث، يفترض أن الأذرع الاستخباراتية في إسرائيل تلقت المعلومات عن هجوم “طوفان الأفصى” قبل وقوعه بإدراك انتقائي متحيز، مما أوقعها في معضلة الجاهزية غير المكتملة للتعامل مع هذا الخطر الوشيك على النحو الأمني الأمثل.
ويفسر هذا الاستنتاج، عدم رفع الاستخبارات الاسرائيلية إنذراً مبكراً للقيادتين السياسية والعسكرية بأن هناك هجوم وشيك محتمل من قطاع غزة أو على أفضل تقدير تم توجيه هذا الإنذار مع التوصية بالتهوين من شأنه وتعظيم قدرة إسرائيل على التصدي الفعال له حال نشوبه، وذلك على غرار ما حدث تماماُ قبل 50 عاماً عشية حرب 6 اكتوبر 1973م المجيدة.
وفي تقديرنا المتواضع، فقد أستندت قيادات الأجهزة الاستخباراتية في إدراكها السياسي المتحيز تجاه استبعاد وقوع هجوم “طوفان الأقصى” إلى المعطيات الاستراتيجية التالية:
– التزام “حماس” الحياد إلى حد كبير خلال جولة المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في مايو 2023م.
فقد أعطى هذا الموقف انطباعاً لدى دوائر الأمن في تل ابيب بوجود حالة من “الاسترخاء العسكري” لدى “حماس” وانها غير راغبة في الدخول في مواجهات عسكرية في الوقت الراهن، لأنها تركز على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

– فقدان “حماس” الدعم الإقليمي مما يقلص مخاطرها الإستراتيجية ضد إسرائيل، فقد خسرت الحركة التحالف مع المحور الراديكالي بقيادة إيران بسبب الأحداث في سورية، وهو ما مثل نقطة تحول فارقة لصالح تعزيز أمن إسرائيل؛ حيث ساهم في تجفيف منابع “حماس”، وخفض مخزونها من الأسلحة والصواريخ، مما قلص هامش المناورة أمامها في اية مواجهات مستقبلية مع إسرائيل.
– التطورات التي تشهدا منطقة الشرق الاوسط، لجهة “تصفير المشاكل الإقليمية”، وتفكيك التحالفات القديمة، وإعادة بناء وتكريس تحالفات بديلة، وذلك على ضوء إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، والتقارب بين القاهرة وأنقرة من جهة، وبين طهران والقاهرة من جهة أخرى، وظهور مؤشرات على قرب “التطبيع” بين السعودية وإسرائيل برعاية أميركية واضحة وكاملة؛ بما تعنيه هذه التغيرات المتسارعة من إيجاد مناخ إقليمي عام غير مواتٍ لأي مواجهة عسكرية ولو على مستوى منخفض من التصعيد في شكل جولات أو معارك صغيرة لا تصل إلى الحرب.
وتتأكد صحة هذا الاستنتاج في ضوء اعترافات كبار المسئولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل بوقوع خطأ استخباراتي تمثل فيتجاهل كبار ضبط الجيش الاسرائيلي لتقارير ومؤشرات تحذر من هجوم محتمل غزة، وذلك على نحو ما ذكرنا أنفاً، وكما سيرد لاحقاً في السطور التالية.
كما تتأكد صوابية هذا الطرح في ضوء ذهاب خبراء ومؤرخين ذوي ثقل للقول بوجود أوجه شبه بين فشل إسرائيل الاستخباراتي عام 1973 وفشلها عام 2023م، معتبرين أن العامل المشترك في هاتين المناسبتين لم يكن -على الأرجح- نقص المعلومات الاستخباراتية، ولكن جودة التحليل والانحيازات المسبقة لمحللي المعلومات والقادة في مجمعات الأمن ودوائر الاستخبارات الإسرائيلية.
ووفقاً لهؤلاء فإن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية – التي يفترض أنها من الأرفع شأنا والأكثر حيطة وحذراً في العالم- وقعت في الفخ نفسه مرة أُخرى حين قللت من رغبة أو قدرة حركة حماس على شن هجوم واسع النطاق، تماما كما قللت تلك الأجهزة من قدرة مصر على دخول الحرب قبل خمسة عقود .
بل اعتبر أنصار هذا الرأي أن هجوم 7 أكتوبر المفاجئ أشد وطأة من ذلك الذي واجهته إسرائيل قبل خمسين عاما أثناء حرب 6 أكتوب، فقد قتلت حركة حماس عددا أكبر من المدنيين الإسرائيليين في أيام الحرب الأولى مقارنة بعدد القتلى الذين تسبَّبت فيهم حرب مصر وسورية على إسرائيل عام 1973، وهُما دولتان كاملتا السيادة تمتلك كل منهما جيشا وطنيا.
علاوة على ذلك، ضربت حماس أهدافا في عُمق إسرائيل، ويبدو من حجم وتعقيد الهجمات التي أصابت أهدافا عديدة وانخرط فيها آلاف المقاتلين أن الهجوم كان قيد التخطيط طيلة أشهر إن لم يكن أطول من ذلك، ما يعني أنه كان من المفترض أن يكون جمع المعلومات الاستخباراتية من غزة أسهل بالنسبة لإسرائيل التي تملك دولة الاحتلال بالفعل أنظمة رقابة ضخمة لا تُقارن بما استخدمته مع مصر وسورية في مطلع السبعينيات.
واستنتاجاً من ذلك، فإن التشتت والبطء الذي ظهر في رد إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023 يشير بقوة بأن قادة اسرائيل السياسيين والعسكريين عانوا من الالتباسات النفسية نفسها التي عانت منها رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير ومستشاروها وكذلك بعض مسؤولي الحكومة الأميركية عام 1973.

ففي كلتا الحالتين، أساء قادة إسرائيل قراءة الخصوم ورد فعلهم المتوقع، وهونوا بشكل مبالغ من قدرتهم على المخاطرة، وبالغوا في تقدير قدرة تل أبيب الخاصة على الردع.
وليس أدل على ذلك، من أنه قبل نحو أسبوع من هجوم 7 أكتوبر، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في حوار لهيئة البث العامة في تل أبيب إن “حماس تمارس درجة عالية من ضبط النفس وتفهم جيدا تبِعات تصعيد المواجهة معنا”.
2)- العوامل المتصلة بـ”حماس”:
– استخدام تكتيكات مراوغة أقنعت من خلالها تل أبيب بأن الحركة مستعدة للتعايش مع خطط التطبيع الإسرائيلي التي كانت جارية مع عدد من الدول العربية مؤخرا.
– ابتكار وسائل هجومية غير اعتيادية ساهمت في خداع مثالي للجيش الاسرائيلي واستخباراته، من خلال استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار “درونز”، وعمليات الإنزال بالمظلات لعناصرها، مما مكنها من تجاور الجدار العازل المزود بكاميرات المراقبة الدقيقة وأدوات الاستشعار عن بُعد( ).
– حيازة معلومات استخباراتة مدنية وعسكرية عن إسرائيل، معظمها غير سري، فيما يعرف بظاهرة “الأسرار غير السرية” واستخدمتها بنجاح في الالتفاف على المراقبة الاستخباراتية الاسرائيلية، وقمت بتنفيذ أكبر هجوم وأكثرها تدميرا في تاريخ إسرائيل.
وبفضل هذه المعلومات، صنعت “حماس” في السابع من أكتوبر 2023م لغزا استخباراتيا جيدا للمكونات الدفاعية الإسرائيلية على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة؛ حيث تم تحييد بعض أجهزة الاستشعار وقدرات الكشف، ومنع السيطرة الفعالة على الأحداث على الجانب الإسرائيلي، وساعد في العمل بفعالية داخل القواعد والبؤر الاستيطانية والمستوطنات التي اقتحمتها خلال الهجوم.
وشمل ذلك معلومات حول مواقع محددة داخل المستوطنات مثل: مواقع فرق الاستجابة الأولى على أي هجوم في فرقة غزة التابعة للجيش الاسرائيلي، وتجمعات الجنود والمدنيين، ومحيط الدفاع عن المستوطنات في غلاف القطاع( ).
رابعاً- الإدارة العسكرية والأمنية لـ”الأزمة – الصدمة”:
بعدما استفاقت إسرائيل من وقع الصدمة الأولى لعملية “طوفان الأقصى”، بعد بضع ساعات، باشرت في اتخاذ حزمة من الإجراءات لإدارة هذه (الأزمة –الصدمة) على مختلف المستويات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية، والمجتمعية، غير أن تفصيل هذه الجوانب يخرج عن نطاق وأهداف هذه الورقة التحليلية.
وتمثل الجانب الأهم في ماهية الإدارة الأمنية والعسكرية، التي حاولت امتصاص هول الصدمة المفاجئة والتقليل من ارتداداتها المحتملة لاسيما على صعيد الجبهة الداخلية.
ومن ثم، بادرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الأحزاب القومية والدينية المتطرفة، إلى تبني خطاب سياسي رسمي واتخاذ إجراءات تصب في تهدئة الشارع الإسرائيلي الغاضب والمحتقن أصلاً منذ اشهر بسبب سياسات هذه الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

فقد هدفت هذه الاجراءات إلى منع ارتفاع سقف مطالب الرأي العام باستقالة حكومة نتنياهو، لاسيما مع الغضب الشارع الاسرائيلي مما حدث وخروج مظاهرات لإعادة الرهائن فوراً.
وتضمن تلك الإجراءات التالي:
– إعلان حالة الحرب رسمياً في نفس يوم الهجوم، بإطلاق عملية عسكرية كبرى باسم “السيوف الحديدية” ضد حركة “حماس” في قطاع غزة رداً على هجوم “طوفان الأقصى”.
– تشكيل حكومة طوارئ أو “كابينت الحرب”، في 11 أكتوبر 2023م، ضمت كل من: نتنياهو، وزعيم المعارضة رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى عضوين اخرين كمراقبين، وهما: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
– سارع جهاز “الشاباك” إلى التحقيق الفوري المتعجل مع الدفعات السبع من المحتجزين الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم “حماس” خلال الهدنة الانسانية المؤقتة في الفترة (24-30 نوفمبر 2023م)، في محاولة للحصول على معلومات تفيد في معرفة أحوال بقية الرهائن في غزة أو تحديد أماكن احتجازهم.
– التأكيد الخطاب الأمني والعسكري الرسمي في أكثر من مناسبة، على العزم على الانتقام من “حماس” على ما فعلته في 7 أكتوبر، بما في ذلك ملاحقة قادتها داخل غزة وخارجها في مختلف دول العالم، حتى لو استغرق الأمر سنوات( ).
– الاعتراف الرسمي على مستوى كبار القيادات العسكرية بوقوع “قصور” و”خلل” استخباراتي، على النحو سالف الذكر، مع إرجاء فتح تحقيقات رسمية في الأمر، لحين انتهاء الحرب.
والواقع أن هذا أمر مألوف ومعتاد في اسرائيل، ومتكرر في حروب سابقة، فعلى سبيل المثال في أعقاب حرب أكتوبر 1973م تم تشكيل (لجنة أجرانات) التي تولت التحقيق مع كبار القادة السياسيين والعسكريين للوقوف على أسباب ما جرى في الحرب خاصة عشية اندلاع وخلال أيامها الأولى.

خامساً- تداعيات الصدمة الاستخباراتية:
وصف استراتيجيون إسرائيليون تداعيات صدمة عملية “طوفان الأقصى” بأنها أعمق وأبعد مما يمكن أن يتصوره عقل( )؛ وذلك في دلالة على عظم وخطورة تلك التداعيات على المستوى الاستراتيجي عموماً، والمستوى العسكري –الأمني على وجه الخصوص.
ويمكن إيجاز هذه التداعيات على النحو التالي:
– تراجع الثقة الشعبية على نحو حاد وغير مسبوق في الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الأمن ومؤسسات الاستخبارات، التي أثبت الهجوم فشلها وكشف اخفاقاتها في توفير الأمن للإسرائيليين، مما أفقدها هيبتها لفترة زمنية لن تكون بالقصيرة على الإطلاق.
– فقدان شعور الاستقرار المبني على الأمن بين قطاع ليس المحدود بين الإسرائليين، وهو الأمر الذي عبر عن نفسه في ارتفاع معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج Reverse Immigration) )، حيث قدرت أعداد اليهود الذين من غادروا ، أو ما يطلق عليهم باللغة العبرية (يورديم)، خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر2023م بأكثر من 230 ألف شخص( ).
ووفق مرتكزات الأمن الاسرائيلي، فإن الهجرة العكسية تصنف باعتبارها “خطراً وجودياً”.
– تآكل مفاهيم مركزية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية( )، التي مُنيت بفشل ذريع إن لم يكن بالانهيار التام، وبخاصة: الردع والإنذار المبكر والدفاع؛ إذ لم يحصل الانذار المبكر، الذي هو مقدمة لازمة لتحقيق الردع، ومن ثم القيام بالتصدي الفعال والفوري لأي هجوم أو خطر.
– يترتب على اهتزاز الردع، تزايد المخاوف من شن خصوم إٍسرائيل في المنطقة وبخاصة (حزب الله في لبنان، وإيران، والحوثيين في اليمن)، هجمات ضدها- وهو ما حدث بالفعل- ظناً منهم أن الفرصة باتت سانحة لتدمير إسرائيل.
وبالتالي، فإن أحد الأهداف غير المعلنة لعملية “السيوف الحديدية” هو ردع هؤلاء الخصوم وغيرهم( ).
فقد وجه احتجاز “حماس” لعدد كبير من الرهائن المدنيين والعسكريين ضربة قاصمة إلى مبدأ الردع الاسرائيلي على نحو ربما يدفع الخصوم للتجرؤ عليها مستقبلاَ؛ إذ أنه في حال الفشل في استعادة هؤلاء الرهائن بالقوة العسكرية- كما هو الحال في الوقت الراهن- فإن ذلك يعني انكشاف أمني خطير ليس فقط على الجبهة الفلسطينية ولكن أيضاً على جبهات أخرى، مما يزيد من احتمالات تكرار هذا السيناريو في المستقبل، سواء في لبنان، أو سورية، وربما أي بقعة في العالم( ).
وربما يتم تطوير آليات وخطط احتجاز الرهائن، جواً و/أو بحراً، على نحو ما فعلت ميليشيات الحوثيين حين احتجزت أكثر من سفينة في البحر الاحمر كونها مملوكة لشركات إسرائيلية أو رجال أعمال إسرائيليين.

بل إنه في الأسابيع الأولى للحرب على غزة، شهدت بعض المطارات في العالم اقتحامات من قبل متظاهرين بعد هبوط طائرات قادمة من تل أبيب والظن بأنها ربما تحمل ركابا إسرائيليين، وذلك على غرار ما شهده مطار “محج قلعة” الرئيسي في جمهورية داغستان التابع للأتحاد الروسي يوم 29 أكتوبر 2023م) (.
– في مقابل التداعيات السابقة أنفة المذكورة أعلاه، عززت التطورات الدولية التي تلت هجوم 7 أكتوبر، واحدة من أهم ركائز العقيدة العسكرية الإسرائيلية، ألا وهي الاعتماد على حليف دولي قوى موثوق به، جنباً إلى جنب مع تقوية مبدأ الاعتماد على الذات.
فقد أبدت الولايات المتحدة الأميركية منذ الساعات الأولى لـ”طوفان الأقصى” –وما تزال- دعماً مطلقاً لإسرائيل، على الصُعد كافة، العسكرية، والاستخباراتية، والسياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والإعلامية، لكن المقام لا يتسع لتفصيل هذا الأمر الواضح للعيان.
سادساً- مستقبل الأمن الإسرائيلي ما بعد صدمة 7 أكتوبر:
ثمة تحول استراتيجي جوهري في النموذج الأمني والاستخباراتي الإٍسرائيلي الذي كان سائداً عشية هجوم 7 أكتوبر، الذي أنشأ واقعاً استراتيجياً جديداً، يقتضي من صناع القرار في تل أبيب إحداث تغيراً دراماتيكياً في ذلك النموذج، بما يساهم في صياغة استراتيجية أمنية واستخباراتية جديدة للسنوات المقبلة.
ووفق رؤى أطروحات قطاع معتبر من النخبة العسكرية والأمنية الإسرائيلية( )، فإن هذا النموذج الجديد ينبغي أن يتضمن الآتي:
1. التحول من الاستراتيجية الدفاعية التي كانت تتبناها قوات الجيش الإسرائيلي الموجودة على حدود قطاع غزة إلى الاستراتيجية الوقائية.
ويعني ذلك العمل على تحويل تركيز الجيش إلى بناء خطوط دفاع ثانوية للتعامل الفوري مع آية خروقات أمنية مفاجئة.

2. إعادة ترميم ما ينبغي ترميمه في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وإعادة هيكلة الأجهزة والمنظومات والأذرع المكلفة بتطبيق هذه العقيدة في المستقبلم، ولاسيما مراجعة وتقييم أداء منظومات الإنذار المبكر القائمة حالياً، بما من شأنه دعم الردع العسكري بمفهومه التقليدي.
3. التوازن في مصادر جمع المعلومات الاستخباراتية، مع زيادة الاعتماد على العنصر البشري في هذا الخصوص.
4. تشديد الرقابة على تدفق المعلومات المدنية والعسكرية، من خلال بعض المبادئ التوجيهية التي يمكن من خلالها التعامل مع المواقف التي تنتشر فيها “الأسرار غير السرية” التي قد يستفيد منها الخصوم على نحو حاسم كما حدث في “طوفان الأقصى”.
وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام بماهية المعلومات المدنية الخاصة بالحماية والرصد والسيطرة، بما في ذلك:
أ) – مقومات حماية الأمن المدني، مثل: فرق الاستجابة الأولى على مختلف الجبهات، وأنظمة الدفاع عن المستوطنات، والتجمعات البشرية التي يمكن أن تكون أهدافا رئيسية لأي هجوم محتمل، سواء كانت دائمة أو عرضية، من قبيل( محطات النقل العام، والحدائق.. إلخ).
ب)- مساكن كبار المسؤولين وأفراد الأمن والقادة المحليين..ألخ.
ج)- الأصول التكنولوجية، مثل: مواقع الويب، والخوادم، وكاميرات المراقبة في القطاعات المدنية.
وفيما يتعلق بالمعلومات العسكرية التي يتم نشرها لأسباب مختلفة من قبل مسؤولي الأمن، يجب إعادة تقييم التوازن بين الاحتياجات الروتينية وأمن المعلومات، فعلى سبيل المثال، يجب إعادة النظر في سياسات التصاريح للفلسطينيين القادمين من غزة للعمل داخل اسرائيل، أو أولئك الذين لديهم صلات محتملة بالفصائل الفلسطينية في غزة.
5. العمل على منع أي تهديد أمني مستقبلي من غزة على إسرائيل.
وقد تضمن خطاب النخبة السياسية والعسكرية والأمنية الإٍسرائيلية، الرسمية وغير الرسمية، عدة بدائل وخيارات لبلوغ هذا الهدف.

ويمكننا إيجاز هذه الخيارات في التالي:
– إعادة احتلال غزة: يقوم هذا الخيار على عودة القوات الإسرائيلية مجدداً لاحتلال القطاع، بحيث يكون تحت سيطرة حكومة عسكرية إسرائيلية كما كانت قبل عام 2005م.
لكن لا يوجد توافق داخل إسرائيل على هذا الخيار، اذ طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكرره في عدة مناسبات نأ الجيش الاسرائيلي سيتولى المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب( ).
ويدعم هذا الخيار أيضاً الرئيس الاسرائيلي إتسحاق هرتسوغ( ). ويؤيده كذلك عدد من الجنرالات الحاليين والمتقاعدين( ). لكن بعض المسئولين في حكومة نتنياهو أكدوا عدم وجود نية لإعادة احتلال غزة.
ويرجع هذا الانقسام إلى الكلفة الباهظة لهذا الخيار عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، كما أن الخبرة التاريخية تثبت فشله على النحو الذي دفع إسرائيل للانسحاب من القطاع في 2005م.
كما تعارض الولايات المتحدة بصورة علنية لا لبس فيها هذا الخيار، حيث أكد الرئيس جو بايدن أكثر من مرة أنه ليس من مصلحة إسرائيل إعادة احتلال غزة ووصف ذلك بأنه سيكون “خطأ كبيرا”. والمعنى ذاته تكرر مراراً على لسان وزير الخارجية انتوني بلينكن ومسئولي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، تبدو فرص تبني هذا الخيار من الناحية العملية تبدو ضئيلة.
– تسهيل عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة: رحبت السلطة بهذا الخيار على لسان كبار مسئوليها وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس.
إلا أن ثمة عقبات تعترض التنفيذ السلس لهذا الخيار، ليس أقلها محدودية خبرة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة وكيفية إدارته، لاسيما مع كون حركة “حماس” متجذرة ومنتشرة في كافة أنحائه، ومن غير المتوقع أن تتنازل عنه بسهولة.
– تدويل إدارة القطاع: وذلك من خلال إدارة عربية، سواءبواسطة دولة واحدة (مصر، أو الأردن، أو السعودية)، أو عبر إدارة جماعية ( ثلاثية مصرية-أردنية-سعودية)، أو إدارة دولية بإشراف الأمم المتحدة.

وقد أبدت العواصم العربية الكبرى اعتراضها أو على أقل تقدير تحفظها على هذا الخيار، لاعتبارات عديدة معروفة ومعلنة لا يتسع مجال وهدف هذه الورقة التحليلية للخوض في تفاصيلها.
– ٌإقامة منطقة عازلة ( Buffer Zone): تفصل بين مستوطنات جنوب إسرائيل (غلاف غزة) وبين شمال القطاع.
وقد سربت إسرائيل جانباً من رؤيتها في هذا الخصوص، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية أن تل أبيب عرضت هذا المقترح على بعض الدول العربية لاستطلاع أرائها بشأنه.
ويقوم هذا الخيار- الذي يعتبر الأكثر واقعية- على أساس إنشاء منطقة عازلة بعمق ما بين 2 إلى 5 كيلو مترات في شمال غزة بطول الحدود مع جنوب مستوطنات غلاف غزة، بما يسمح بتوسيع نطاق المراقبة، وتقليص فرص تكرار هجوم 7 أكتوبر( ).
ولايمنع ما سبق، أن يتم دمج أكثر من خيار من الخيارات السابقة معاً، فعلى سبيل المثال قد يتم إنشاء منطقة عازلة بالتزامن مع عودة حكم السلطة الفلسطينية لغزة أو وجود إدارة عربية أودولية للقطاع بصيغة ما
*عميد كلية العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية- جامعة (أهومي) البريطانية- المملكة المتحدة*